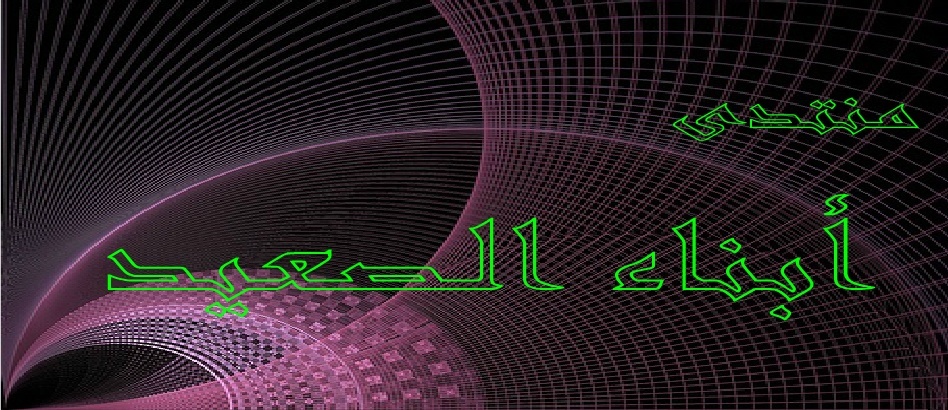]إلى وقت قريب كانت لا تخلو قرية في الريف المصري من سيدة أو أكثر عُرف عنها القدرة على الندب والنواح في مناسبة العزاء وغالباً ما تقوم بذلك مجاملة لأسرة المتوفى وكنوع من المشاطرة الوجدانية لما يمرون به من فاجعة، وأحياناً أخرى تتقاضى أجراً يختلف حسب الوضع الاجتماعي لأسرة الفقيد، فالأغنياء يمنحونها نقوداً ولا مانع وهي تغادر المكان مساء كل يوم من إعطائها شنطة تحتوي على لحوم وأرز وفطائر و«كيلو من البن»، بينما الفقراء يكتفون بأصناف من الطعام الذي يتم طهيه خصيصاً لمن حضر لأداء واجب العزاء وذلك في ثلاثة أوانٍ، يحتوي الأول على كيلو من اللحم والثاني على الأرز والثالث على صنف الخضار، وهو غالباً ما يكون بطاطس وهم يودعونها «متشكرين يا خالة» لاسيما أن الفقراء غالباً لا يستأجرون «مِعدّدة» خاصة أن الأمر يقتصر على امرأة من العائلة تكون لديها القدرة على أداء مهام المِعدّدة!.
وحكايات تلك النسوة محترفات العمل في استدرار البكاء، تختلف من امرأة لأخرى وإن كُنَّ يرفضن الاعتراف أو المجاهرة بأنهن يعملن «ندابة» أو كما يحلو للمصريين وصفها بـ «المِعدّدة» وذلك تفادياً لنظرة المجتمع لها ولأبنائها، خاصة أنها كمهنة تعد نذير شؤم على من تحلّ بباب داره كما يحلو لأطفال القرية عند اختلافهم مع أحد أبنائها أن ينعتوه «يا ابن الندابة» مما يجعله يهرول لأمه وهو يبكي، وهو ما يعد المسمار الأول في نعش أقدم مهنة في التاريخ، فباسم الوجاهة الاجتماعية وكلام الناس هجرت أعداد كبيرة من النساء العمل في تلك المهنة ومن بقيت في هذا المجال تعاني البطالة أغلب فترات العام جرّاء تغير مفاهيم الكثير باسم المدنية والحياة العصرية!.
وعلى الرغم من ذلك فإن حكايات من بقيت منهن مثيرة لاسيما في الأمور المتعلقة بطقوس المهنة فهذه «سعدية الشهيرة بأم فتحي» امرأة في العقد الخامس من العمر تعيش في محافظة الشرقية 60 كيلو متراً شمال شرق القاهرة يطلبها الجميع في مناسبات الوفاة تحديداً فتأتي وهي ترتدي ملابس سوداء «جلابية فضفاضة وإيشارب أسود وتمسك في يدها بايشارب آخر أسود اللون أيضاً» وتجلس على كنبة وسط بيت المتوفى منذ الوفاة إلى الدفن مروراً بالغُسل وتجهيز الميت للدفن، وبعد أن تتعرف على معلومات عامة عن أبرز خصائص الفقيد (رجل أو أنثي، شاب أم طاعن في السن، طفل وحيد أم له إخوة، وملابسات الوفاة.. طبيعية، غريق أم صعقته الكهرباء، مات في الغربة أم بين أهله وهكذا) بعدها تطلق التنهيدة تلو الأخرى أثناء إنصاتها للتلاوة القرآنية التي تُفتَتح بها طقوس العزاء في مصر ثم تتناول كوب الماء الساخن المُحَلَّى بثلاث ملاعق سكر «كي تمنحها نوعاً من الطاقة» تفيدها فيما هي مقبلة عليه، وبعدها تتلفت يميناً ويساراً وهي تردد إذا كان الفقيد مثلاً رجلاً متزوجاً وله أولاد صغار: «يا غالي.. يا غالي.. يا جملي يا سبعي.. رحت وسبتنا لمين.. والعيال هيقولوا لمين يابا من بعدك.. ثم تبدأ في الولولة مصحوبة بصرخات عالية يحلو لأهل الريف وصفها بـ (الصوت الحيّانِي)» وتقاس حرفية ومهارة المِعدّدة بقوة الصوت الحيّانِي «والذي يلعب دوراً كبيراً في استدرار الدموع من أعين النسوة الحاضرات لأداء واجب العزاء فتبادر إحدى الجالسات وغالباً ما تكون قريبة الصلة بالميت كالأم أو الزوجة أو الأخت.. بتحيتها بصوت آخر حيّانِي وهي تردد «حبيبة والله يا خالة» مع لطم الخدود في حركات منتظمة وهي تردد «يالهوي يالهوي، ياخرابي، ليَّا مين بعده».. وأخرى: «أي والنبي يا خالة كان غالي والله ومالي علينا الدار وهو سندنا وعزوتنا».. وثالثة «كان راجل من يومه وعمر العيبة ما طلعت منه»..
ووقتها تتيقن «المِعدّدة» أن بالعزاء من يقدِّرن أداءها فيعلو صوتها بالصوت الحيّانِي وتبدأ في ترديد ما تحفظ من مواويل وأغانٍ حزينة بعضها ينتمي للفولكلور الشعبي مثل هذا الذي تقوله في أثناء عملية غسل الميت: «كام ياغسال تدهيني؟ تخلع هدوم الزين وتديني
كام يا غسال ترجفني؟ تخلع هدوم الزين وتحدفني»
وبعد الغُسل وفي أثناء الذهاب به إلى المقابر لدفنه تقول المِعدّدة على لسان الميت:
(ولا تنزلوني القبر بالعاصي حالق جديد لا تعكسوا راسي
ولا تنزلوني القبر بالهمة لابس جديد لا تعكسو العمة)
وهناك مرثيات أخرى من نسج خيال المِعدّدة نفسها ويكون وليد اللحظة.
الأصل فرعوني
تذكر كتب التاريخ أن نساء الفراعنة هم أول من لجأ إلى التعبير عن الحزن بالعويل والعديد والنواح.. فحسب المؤرخ هيرودوت فإن المعددة أو من يمتهنّ الغناء الحزين في الطقوس الجنائزية كان الفراعنة يلقبونهم بـ (مانيروس) وهم نوع من الكهنة تخصص في بكاء الموتى واستدرار الدموع فيصطفون حول المقبرة وهم يغنون ويرتلون أغنيات جنائزية وبمرور الوقت باتت هناك طائفة عملها هذا النوع من الغناء وهم دائماً من النساء، وأطلق عليهم المصريون وصف «العديد» وصاحبة المهنة هي المِعدّدة (التي ترثي الميت بشعر مغنَّى)، ويستأجرها أهل المتوفى للتغني بصفاته الحميدة.. وقد استوقفت تلك الظاهرة العديد من المؤرخين والباحثين في التراث الشعبي المصري أبرزهم في العصر الحديث «جاستون ماسبيرو» (وهو عالم فرنسي بالآثار المصرية عاش في مصر مطلع القرن العشرين وحرص على جمع الأغاني الشعبية في صعيد مصر) في كتاب اختار له عنواناً يحمل الاسم نفسه «العديد»، وقد خصص أحد أبوابه للغناء الجنائزي وهو ما يشير إليه الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، موضحاً أنه واحد من أهم الكتب والدراسات التي تناولت هذا النوع من الأدب والموروث الشعبي، موضحاً أن مؤرخي الأدب الشعبي والفولكلور المصري توقفوا كثيراً أمام ظاهرة «المِعدّدة» أو الندَّابة فرصدها باحثون كثيرون إلى جانب ماسبيرو منهم الدكتور درويش الأسيوطي في السبعينيات من القرن الماضي وكذلك الباحث أحمد توفيق، وعن نفسي فقد اهتممت أيضاً بتلك الظاهرة وقمت بعمل دراسة عنها بعنوان «المِعدّدة تشعر وكل واحد يبكي على حاله» وكشفت تلك الدراسة عن كون الندابة أو العديد هي بمثابة نوع من التواصل الاجتماعي، بمعنى أن المعددة في الريف تمثل الشعور الجمعي لأهل القرية الذين هزتهم فاجعة الموت وتأخذ المعددة على عاتقها توحيد حزنهم ومشاعرهم وإعادة تذكيرهم بمآثر ومحاسن الفقيد، بينما الأمر يختلف في المدينة التي يغيب فيها هذا النوع من المشاركة الوجدانية والتواصل بفعل طغيان الفردية والحياة الانعزالية لكل أسرة بعيداً عن الأخرى، ولذا لم يكن من المستغرب أن تقل الظاهرة في المدينة أولاً قبل أن تبدأ في الانحسار تدريجياً في الريف ليكون الأمر قاصراً على البكاء والنواح فقط.
ويرى أن الندابة أو المعددة هي جزء مهم من الثقافة الشعبية ويقول: يجب أن نفرِّق بين المعددة التي تعمل في المدن بأجر وتتخذ من العديد في الأحزان مهنة تتكسب منها، والمعددة في الأرياف وصعيد مصر والتي تحضر مجاملة لأسرة المتوفى، وغالباً ما تكون من أقارب المتوفى لاسيما وأنك كلما ابتعدت عن المدن وجدت نوعاً من المودة الكبيرة بين الناس وتغلب المجاملات الاجتماعية في الأفراح والأحزان.
ويضيف: رثاء الموتى ظاهرة ليست قاصرة على المصريين وحدهم وإنما كل شعوب العالم لديها ما يعرف بالرثاء والحزن على الموتى ولكن الظاهرة تختلف من مكان لآخر، فالشعر العربي مثلا يزخر بآلاف من المرثيات في الحزن تحديداً، ولو شئنا لاعتبرناها تدخل في نطاق العديد لعل أبرزها شعر الخنساء.
وهناك من رثى الملوك أو رثى فقيداً عزيزاً عليه كابن الرومي.. والفرق بين شعر الرثاء وما تقوله المعددة هو أن الأول قاله شاعر ولا يجد الناس حرجاً أو انتقاصاً لمكانتهم الاجتماعية من إعادة ترديده في أوقات أخرى وهم يفتخرون بأنه عن الشاعر «الفلاني» بينما العديد يقتصر قوله وتريده على المناسبة وفي وقتها فقط ولا يحبذ الناس إعادة ترديده حتى لا ينظر لهم المحيطون بهم على أنهم فأل سيئ.
وتابع: من الملاحظ في السنوات الأخيرة أن ظاهرة الندابة أو المعددة آخذة في التراجع سواء في المدينة أو في الريف المصري، وهذا يرجع لسببين.. الأول هو الاعتقاد بأن وجود مثل تلك المرأة في مناسبات الحزن يقلل من الوجاهة الاجتماعية لأسرة المتوفى وهي نظرة يتبعها أهل المدن على اعتبار أن المعددة مظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي.. والأمر الثاني خاص بأهل الريف ومحاربة رجال الدين لمظاهر الغلوّ في الحزن واعتقادهم أن المعددة أو الندابة بمثابة بدعة تبعد من حضروا العزاء عن التذكّر والتدبر في مفهوم الموت وأن الحياة قصيرة والاعتبار مما حدث، ولذلك تقل يوماً بعد يوم ظاهرة المعددة في الحياة الاجتماعية.
ويوافقه الرأي د.إبراهيم أحمد شعلان أستاذ الأدب الشعبي الزائر بالجامعات العربية وصاحب موسوعة الأمثال الشعبية، ويضيف: المعددة كما هو دارج في اللغة العامية للمصريين تعتبر جزءاً مهماً ورئيسياً في المناسبات الحزينة،فهي يقع على عاتقها مسؤولية استدرار الحزن والدموع من أعين الحضور وجعلهم يعيشون الحدث بكل ما به من فاجعة وألم كما لو كانوا أحد المقربين من الميت، حيث نرى أن الحضور يبكون بشدة وإذا سألت أحداً وصدقك القول فتراه يقول: أنا تذكرت أبي أو أخي وربما ابني، وهكذا تنوح المعددة وكلٌ يبكي على فجيعته كما يقول المثل «كلٌ يبكي على ليلاه».
وتابع: ليست كل امرأة تستطيع أن تكون معددة وتمارس هذه المهمة في المناسبات المختلفة بعيداً عن محيط أسرتها، ولكنها مهنة واحتراف بالمعنى الدارج اليوم، فأولاً يجب أن تكون حسنة الصوت وتجيد مخارج الحروف فلا يعقل أن يكون صوتها أجش أو تتهته أو تلثغ في عدة حروف، فوقتها سوف ينفجر الحضور في موجة من الضحك ويبتعدون عن الجو العام للحزن، كما يجب أن تكون صاحبة قدرة فائقة على الحفظ وإجادة القول المناسب لكل حدث، فرثاء طفل غير رثاء رجل عجوز أو زوج، فعلى قدر الفاجعة ومدى قرب الميت وتأثيره في أسرته يكون رثاؤها وإلا كانت كمن يعزف نشاز فتخرج عليها النسوة المعزيات «بتقول إيه الست دي.. اسكتي أحسن لك وفارقينا أو سيبينا في همنا إحنا اعلم بمصيبتنا» وغيرها من الكلمات اللاذعة.
ولذا فمن تتصدى للعمل كمعددة أرى أنها تتمتع بقدر كبير من الذكاء والفطنة والكياسة، وهذه الصفات ليست مرتبطة بالقدر الذي نالته من التعليم، فغالبية المعددات أميات، ومع ذلك يتمتعن بقدرة فائقة على الحفظ وذلك يعود أولاً إلى حبها لتلك المهنة منذ الصغر لاسيما أنها مهنة متوارثة أمّاً عن جدة، فكثير من المعددات أمهاتهن في الأصل معددة وقد علمتها منذ الصغر حفظ وترديد ما تقوله، ولذا لم تندثر الكثير من المرثيات الشعبية والتي في غالبيتها لها أصل فرعوني، وهذا الأمر ليس بغريب خاصة أن الفراعنة هم بطبيعة عاداتهم أول من ابتدع الندابة ورثاء الموتى وهذا ثابت على جدران المعابد وفي البرديات المختلفة، وقصة إيزيس وأوزريس تحتوي على الكثير من الرثاء للفقيد والحزن البالغ على الميت.
العيب وكلام الناس!
في العصر الحديث تراجعت كثير من الأسر خاصة في المدن عن الاستعانة بالمعددة في مناسبات الوفاة وذلك بدعوى أنها ترمز إلى الرجعية والتخلف ولا تمت للعصرية والتحضر بصلة، كما تقول سميرة علي مدرسة لغة إنجليزية: «الحزن في القلب.. ممكن أبكي وأصرخ لكن لطم الخدود لا، والاستعانة بمعددة مستحيل».
وتمضي قائلة: أمي ماتت منذ خمس سنوات ووقتها كنت متزوجة حديثاً وفؤجئت بخالتي تشير عليّ بأن نستأجر معددة، فقلت لها: معقول معددة مش ممكن أبداً.. ووقتها لم أجد مبرراً لنظرة الغضب التي رمقتني بها خالتي، وعندما سألتها فوجئت بها تقول: أمك ألا تستحق أن يبكيها الجميع فقلت لها وما الذي يمنع محبيها من البكاء، فقالت: الناس بتحضر إلى العزاء وبتكون جالسة بأجسادها لكن عقلها وتفكيرها بيكون مشغول في حاجات تانية ولو الواحدة بكت بتكون دمعة أو دمعتين بالكاد ولكن في وجود المعددة هتقدر إزاي تجعلهم يبكون على مدار ساعة واثنين وثلاثة لغاية عينيهم ما تتوهج احمراراً من فرط البكاء.
فقلت لها غريبة احنا هنخلي الناس تبكي غصب عنها.. الحب والوفاء دايما بيكونوا نابعين من القلب وليسوا في حاجة إلى مظاهر كذابة للتعبير عنهم.
وتضيف: أنا في حياتي اليومية ممكن أبكي تأثراً بموقف شاهدته أو بحدث مررت به وبعدها أشعر براحة نفسية كبيرة، وأنا عندما أبكي لا أكون أخضع لتأثير شحن معنوي من معددة أو غيرها، لأن اللي في القلب في القلب.
وتشاركها الرأي دينا وحيد 19 سنة طالبة في كلية الآداب وتقول: عادي جداً إني أبكي وممكن أصرخ في الشارع أو البيت أو في الجامعة بين صديقاتي مش فارقة، المهم اللي جوايا أقدر أعبر عنه في لحظتها دون زيف أو خداع ومسألة إني أداري مشاعري بدعوى العيب وكلام الناس أراها من الأمور القديمة قوي وغير المألوفة في زماننا، فما الذي يضر الناس أن هناك من يبكي أو يعبر عن مشاعر حزن يمر بها وما الذي سيستفيده الآخرون إذا رأوني أبدل حزني بالفرح والسعادة أو أن أصمت وأتجهم ولا أنطق بكلمة ولا أبيّن من مشاعري شيئاً وأكون في نقطة الصفر مثلاً.. في كل الأحوال الناس لو عاوزة تنتقدني هتنتقدني بصورة أو بأخرى يبقى ليه أخفي مشاعري وأعيش الحياة بأكثر من شخصية وأضغط على أعصابي طول الوقت كي أرضي الآخرين.
وتقول فاطمة الشافعي 71 سنة ربة منزل: لازم الواحدة تبكي بحرقة وتصرخ وتلطم الخدود لو استدعى الأمر للتعبير عن حزنها ولو ما كانتش تعمل كده لفراق الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن.. لا قدَّر الله.. يبقى ازاي تكون زعلانة لازم الواحدة تدي كل حاجة حقها ولو مش قادرة تعيط بحرقة تجيب معددة وتبكي وراها، أنا عشت كده وأمي وجدّتي من قبل عاشوا كده ولكن ولادي حياتهم مختلفة، البنت الكبيرة تخرجت في كلية الهندسة وعايشة مع زوجها في مصر – تقصد القاهرة - وكل حاجة عندها محسوبة.. ده عيب وده ما يصحش.. وده الناس تقول علينا إيه.. ويا عيني يوم ما بنتها تعبت وأجرى لها الأطباء عملية الزائدة الدودية لم أرَ في عينيها دمعة واحدة وظلت طول الوقت في المستشفى تتعامل كما لو كانت رجلاً، وعندما عدنا إلى البيت اختفت فجأة في حجرتها وعندما دخلت إليها وجدتها تبكي بشدة وعينها حمراء كما لو كانت غرقانة دم.
ظاهرة نفسية
ومن جانبه يرى الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن البكاء كسلوك إنساني يعد من الأمور الحميدة فهو يعبر عن شخصية سوية ويعد بمثابة متنفس طبيعي عن مناسبة يمر بها الإنسان سواء كانت مناسبة سعيدة أو حزينة ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل.
ويقول: في حالة الفاجعة الكبرى والمتمثلة في الموت وهي ذروة المشاعر الحزينة لأي انسان وخاصة المرأة فتمر بأربع مراحل نفسية، الأولى عدم التصديق فنراها تنكر حدوث الموت وتقول زوجي حي لم يمت وأنا هاحضر له الغداء أو أكوي له هدومه وهكذا.. ثم تنتقل بعدها إلى مرحلة التهيؤات أو الهلوثة فتقول سمعت صوته في المنزل أو رائحته لا تزال موجودة في الملابس وصورته على الحائط بتكلمني أو بتنظر إليّ وتقول لي خلي بالك من الأولاد، وهكذا إلى أن تمضي الأربعين يوماً الأولى على الوفاة فتبدأ تصدق أن الوفاة حدثت بالفعل فتحزن وبمرور الوقت تقل مساحة الحزن بداخلها إلى أن تصل لمرحلة النسيان وتقبل الأمر.
ولكن هناك أناسا تكون الأمور مختلفة بالنسبة لهم وهم نعرفهم في علم النفس بالشخصيات غير السوية أو المضطربة حيث تتأخر كل مرحلة من مراحل الحزن الأربع لديها كثيراً، وهنا يأتي دور المعددة أو الندابة ومن خلال ما تردده من شعر وما تقوله من رثاء بصوت شجي تجعل المرأة تعيش مرحلة التصديق بأمر الوفاة فورياً وتحزن وتبكي خلال الثلاثة أيام الأولى من الوفاة على الفقيد، حيث تنجح المعددة في جعل الإنكار حقيقة بما تمارسه من ضغوط نفسية قوية جداً على الحضور قيقل إنكارهم للحدث بسرعة كبيرة ويصدقوا أن قريبهم قد توفي فيبدأون مرحلة الحزن والبكاء.
ويرى الدكتور هاشم بحري أن المعددة تلعب دوراً مهماً في استعادة المرأة تحديداً لحالتها النفسية بصورة صحيحة، عكس الرجل، فعلى الرغم من كون مشاعر المرأة لا تختلف كثيراً عن مشاعر الرجل خاصة في الأمور المتعلقة بالحزن والبكاء فإن وجود مهام أخرى للرجل من قيامه بواجبات تقبل العزاء إلى الخروج لعمل وتلبية احتياجات الأسرة بسرعة متغلباً على أحزانه تجعله يدخل بسرعة في مرحلة التصديق والحزن دون الحاجة إلى «معددة» أو بمن يذكره بمآثر المتوفى.
ويوضح خبير الطب النفسي أن ظاهرة المعددة سبق وأن شاهدها عن قرب أثناء تواجده أخيراً في المكسيك، حيث كان يجد إعلانات لفرق تمثيلية كل مهمتها أن تحضر إلى مكان العزاء في الكنيسة أو البيت وتقدم أغاني حزينة أشبه بالمرثيات عن المتوفى بهدف استدرار الدموع والحزن من جمهور الحضور.وعن سر لجوء المرأة إلى البكاء والصراخ والولولة أيضاً في بعض الأحيان عكس الرجل قال: المجتمع هو من فرض ذلك وسمح به، فالمجتمعات الشرقية تحديداً لا تحبذ أن ترى الرجل يبكي وإن بكى فلا يجب أن يتمادى بالصراخ ولسان حال الجميع يقول: «ماذا نفعل لك.. أنت رجل يجب عليك التحمل» ولذا فإن الرجل في مجتمعنا الشرقي تربى على كتمان مشاعره لا سيما عند الحزن، ولذا فكثير من الرجال عند الحزن يدخلون في غرف مغلقة ويبكون وينتحبون كما يشاؤون ويحرصون على ألا يشاهد بكاءهم أحد إلا المقربون منهم جداً كالأصدقاء وفي أحيان يرفض الرجل أن يبكي أمام أبنائه أو إخوته أو زوجته كي لا يفقد هيبته أمامهم أو يسهم في فقدانهم للتماسك والقدرة على الاحتمال باعتباره يجب أن يكون قدوة لهم.بينما الأمر مختلف بالنسبة للمرأة فالمجتمع لا يمانع بل ويرحب عندما يراها تبكي أو تصرخ تحت مسمى أن المرأة كائن ضعيف وأن بكاءها وصرخاتها هي بدافع التعبير عن الحزن وطلباً للنجدة وللمواساة فيهرع من يسمع بكاءها وصرخاتها إلى مساندتها معنوياً ومحاولة التخفيف عنها ومشاطرتها الحزن وأيضاً الفرح فالمرأة تبكي أيضاً إذا مرت بمناسبة سعيدة وتصرخ كذلك وهي أيضاً تعني بذلك أن تخبر الجميع بالأمر وأن يشاطروها ما تمر به من مناسبة.