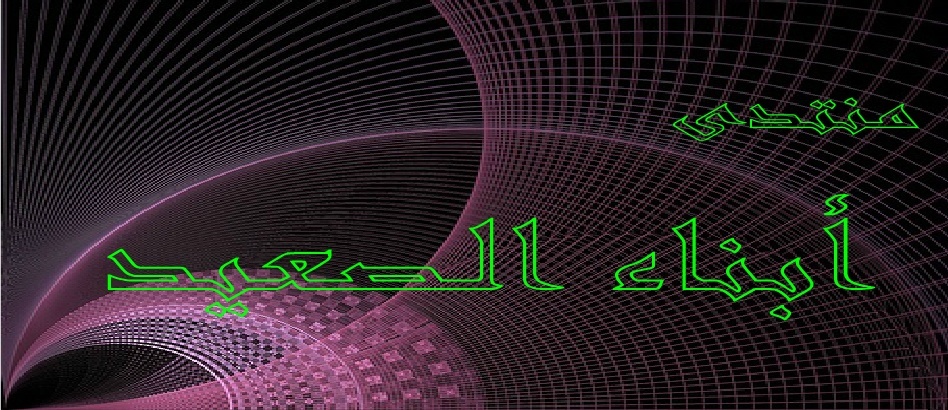حوار مع الشاعر عبد الرحمن الابنودي : قريتي خرجتني شاعرا وأبي مزق ديواني الأول لأنه بالعامية

الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي
في بيته بحي الزمالك الراقي بالقاهرة، ومع كوب من الشاي بالنعناع أعده بنفسه لي، فتح الشاعر عبد الرحمن الأبنودي خزانة أسراره، تحدث بحماس واستفاضة عن طفولته ومسيرته الشعرية، وبأسى وشجن تحدث عن ثقافة مصر، وما أصابها من ترد وخواء، في زمن وصفه بـ«زمن الباعة». كما تحدث الأبنودي عن الأغنية وموقفه مما يحدث على ساحتها الآن، ورؤيته لفترة اعتقاله في عهد عبد الناصر، والتي وصفها بأنها كانت فترة جميلة، أدرك من خلالها القيمة الحقيقية للحرية. وتطرق الحديث إلى عدد من قضايا الفن والثقافة. وهنا نص المقابلة:
كيف ترى الآن بدايتك كشاعر، وما هي المحطات الأساسية التي أثرت في رحلتك مع الشعر؟
كان لا بد أن أتخرج من قريتي «أبنود» شاعراً، حيث كل إنسان في هذه القرية يغني. فهم يغنون أثناء العمل، وفي أوقات الراحة وأحيانا يستبدلون الغناء بالشعر. وتجدهم أثناء دورانهم حول السواقي يغنون، وفي أوقات دهس القمح يغنون. والنساء بدورهن حين ينفردن في الدور يغنين تلك البكائيات الرائعة التي أعتبرها من أدبيات الشعر العربي. وفي قريتي حين تقام الأفراح يغنون لأنفسهم ولا يجعلون أحدا من خارج قريتهم يغني بدلاً منهم. كل هذا يعطيك دلالة على أن الغناء هو البطل في هذه القرية. وعندما كنت صغيرا لم أتجاوز الثمانية أعوام، كنت أذهب إلى الغيط لجمع القطن، وإلى الحطابين لجمع السنابل من بقايا الزرع. هذه أعمال كنت أقوم بها وأنا أغني. كنت راعي غنم وجامع قطن وأذهب إلى النهر لأصطاد سمكتي لكي أعيش. كنت فقيراً وكان الغناء دائماً يحاصرني. وحين دخلت المدرسة الابتدائية تفتح أفقي وبدأت أسأل نفسي وأفكر، لماذا لا يدرّسون الأغاني والأشعار في المدرسة؟ وصرت استغرب حين أستمع إلى الراديو وما به من أغانٍ بلا قيمة، في حين ان قريتي كانت تعج بمئات القصائد والأغاني الرائعة.
لكن طموحك كشاعر فاجأك حينما ذهبت إلى القاهرة، وهو ما جعلك تفكر في الكتابة الشعرية الغنائية؟
لم أكن أتخيل أبداً أنني سأذهب إلى القاهرة وأكتب الشعر والأغاني. لكن بعد انتقالي إلى العاصمة، بدأت بعض الصحف والمجلات تنشر قصائدي، والناس في الشوارع يرددون أبياتا من أغنياتي. لم أذهب إلى مطربين لكي يغنوا أشعاري، ولم أفكر في الكتابة بشكل جاد، إلى ان طلبوني في الإذاعة المصرية، واختاروا إحدى أغنياتي المنشورة وأشهرها «تحت الشجر يا وهيبة» التي صنعت نجماً غنائياً كبيرا هو المرحوم محمد رشدي. هنا بدأت علاقتي بالرجل واستمرت حتى آخر يوم في حياته.
هل نستطيع أن نقول إن الطبيعة لعبت الدور الأهم في صقل وتنمية موهبتك؟
الطبيعة هي أم لموهبتي وتجربتي. عندما أشعر بالفراغ الفكري، أذهب إلى قريتي أبنود لاستعادة الذاكرة والتشبع. أنا على صلة دائمة بقريتي وأزورها في المناسبات السعيدة وغير السعيدة. هناك ثلاث تجارب في حياتي مهمة، جعلتني مختلفاً عن سائر الشعراء. الأولى هي تجربتي في أبنود. وعندما أتحدث عن تجربة القرية، فأنا لا أتحدث عن تجربة شاهدتها عن بعد، وإنما عايشتها لأنني أحد هؤلاء الفلاحين الذين عرفوا الشقاء ولم يشاهدوه من خلف نافذة زجاجية.
التجربة الثانية: هي السجن، حيث تم اعتقالي في فترة (1966– 1967) مع خيرة المفكرين والأدباء في الوطن العربي، في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر حيث كانت أشواقنا ارتفعت من رؤوسنا، وكان هذا يزعج السلطات. وبرغم أن عبد الناصر كان رئيسا عظيما، كان أسلوب حكمه بوليسيا، وكنا مراقبين في بيوتنا، وفي كل مكان. في المعتقل كان معي الروائي جمال الغيطاني، وصلاح عيسي، والكاتب الأردني غالب هلسا الذي له فضل كبير على جيل الستينيات ولم يأخذ حقه الأدبي. وكان معنا الكاتب أحمد فتحي، والشاعر سيد حجاب، والصحافي محمد العزبي. كنا مجموعة جميلة من خيرة أدباء مصر.
هل كان انعكاس تجربة السجن سلبياً أم ايجابياً على شعرك؟
جدار السجن هو اخر جدار في العالم تستند إليه، لتعرف بالضبط قيمة ما يحتويه البدن من فكر ومواقف. إما أن تحس بالورطة وتفكر في كيفية الخروج منها، أو أن تحس ان هذا هو مكانك الطبيعي الذي تستحقه وهو بمثابة العودة إلى الرحم. تجربة الاعتقال جعلتني أتعرف أكثر على غالب هلسا الذي عرفته كل سجون الوطن العربي. علمتني هذه التجربة ان المبدع الحقيقي سيظل دائما في حالة صدام مع السلطة، لأن المبدع له طموح لا تقف أمامه عوائق. المبدع أفقه أوسع من السياسي ويرغب في الحوار والنقاش، ولكن لا وقت للسلطات البوليسية والعسكرية للحوار، والأفضل عندها أن تحبسه مع لسانه في زنزانة لتتخلص منه. دائما أسأل نفسي من واقع تلك التجربة: كيف بالله يمكنك أن تكتب عن الحرية إن لم تعش تجربة السجن. كنا في الماضي نرسم صورة لقفص حديدي، تخرج منه حمامة، ونقول هذه هي الحرية، لكن الحرية شيء آخر.
لكن ماذا عن التجربة الثالثة؟
هي تجربة الحرب، كيف تكتب عن النضال والصراع والمحاربين وأنت لا تعرف الحرب، هذا لا يصح. هيمنغواي، عاش تجربة الحرب الثانية، وكتب رائعته «وداعا للسلاح». وكثير من الكتاب عندما أرادوا أن يكتبوا عن الحرب ذهبوا إلى مناطق اشتعالها لكي يتعايشوا مع التجربة، ويكتبوا بصدق. وهناك من يكتب عن افريقيا وهو لم يسافر إلى أدغالها، هذا غير مقنع. ولذلك من يكتبون عن الحرب ويصفون وجه الشهيد بأنه مبتسم مخرفون، لأنني رأيت وجوه الشهداء فزعة. ولا يستطيع واحدهم أن يفكر في غير ما هو أمامه. حاولت أثناء وجودي بالحرب أن أستجمع صورة والدتي، ولم أستطع. أثناء وجودي على الجبهة بحرب الاستنزاف لمدة ثلاث سنوات ونصف، استطعت أن أكتب أهم أغنياتي «موال النهار» و«المسيح»، و«بيوت السويس»، وملحمتي «بيوت على الشط». فمصر لا تستشعر روحها في المدن المزدحمة، ولا في القرى الساكنة وإنما في بعض البؤر الخاصة. هذه الروح كانت موجودة أيام عبد الناصر، لكن نفتقدها الآن.
فمثلاً أثناء بناء السد العالي ذهبت إلى هناك وسط العمال والفلاحين، وكتبت أهم دواويني «جوابات حراجي القطن». حين أذهب لأي مكان، لا أدون مذكرات كما يفعل البعض، إنما أعيش التجربة وأنساها، وعندما تنضج الفكرة بداخلي يخرج هؤلاء الناس في صورة قصائد. هذه التجارب الثلاث وهبتني محبة الحرية والحياة، والذي أحب أن أقوله هو أنني هذا الإنسان الذي جاء من قرية بجنوب مصر وفي جيبه ثلاثة جنيهات، وأصبح عنده هذا المنزل، وابنتان، وعاش تجربة الزواج والإنجاب على كبر. إنها تجربة صعبة عندما يكون بينك وبين ابنتك الأولى 45 عاما والثانية 50 عاما. الأولى في الجامعة والثانية في المرحلة الثانوية. أعطيتهما الحرية كاملة، ولم أمارس عليهما الضغوط التي مارسها علي الشيخ الأبنودي حينما قام بتمزيق أول ديوان شعر لي دون أن يسألني، لأنه مكتوب باللغة العامية.
لماذا تكتب إذن؟
الكتابة هي المبرر الوحيد لوجودي، فهي تسهل لي أن أفضح المسافة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء. حين أتأمل العمال الذين يبنون ويرصفون الطرق والفلاحين الذين يزرعون ولا يجدون قوت يومهم، حين أتأمل الأطفال المشردين في الشوارع، تصبح الكتابة حينئذ مهمة نبيلة للدفاع عنهم.
هل أنت دائماً مهموم بقضايا الفقراء البسطاء؟
مهموم بكل قضايا الإنسان. لا أدعي معرفتي بكل هموم العالم، ولكن يكفي أن أقوم بقياس الهموم على بسطاء وفقراء قريتي أبنود، وما يحدث الآن في المجتمع المصري من انهيار وفساد، واندماج النظام بالسلطة إلى حد مفزع، وعدم الإحساس بالظلم، وبيع مقدرات الشعب بالمجان، كل هذا يمنحني إيمانا راسخا بعدالة ما أكتب.
هل ترى أنك حققت رؤيتك، ولم تمارس معها نوعا من «التساهل المذنب»؟
لم أخن رؤيتي وحققت أجزاء منها. عشت كثيراً، وفترة الإبداع عندي طويلة فمنذ عام 1956 حتى الآن وأنا أكتب، أي على مدار نصف قرن تقريبا ما زال عطائي مستمرا، ولم يتوقف عند إصداري ثمانية عشر ديواناً، وإنما استطعت أن أجمع «سيرة بني هلال» التي التهمت من عمري ما يقارب الثلاثين سنة، ظللت أبحث عنها في الجبال والنجوع والقرى، وأسافر في البلاد لجمعها. ولولا أن وفقني الله في جمعها في هذا التوقيت ما جُمعت وضاعت. والعجيب أن جابر أبو حسين، هذا الرجل العظيم الذي سجلت معه السيرة الهلالية، مات بعد تفسير السيرة مباشرة. وسيد الضوّ، التلميذ الكبير لجابر أبو حسين، يقوم كل عام في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان بإلقاء السيرة في التجمعات الشعبية. الذي يرضيني أن سيرة «بني هلال» أصبحت تدرس في الجامعات الأمريكية والأوروبية في فرنسا وأسبانيا وعدة دول أخرى، وهناك آلاف من رسائل الدكتوراة حولها.
لكنك استفدت مادياً من «سيرة بني هلال»؟
بالعكس، حين كنت في الستينات فقيراً مثل سائر مثقفي مصر في عهد عبد الناصر، كان عندي جهاز تسجيل ثقيل أحضره لي المرحوم عبد الحليم حافظ. عندما كنت أعلم أن هناك إنسـاناً عنده أشياء مهمة من سيرة بني هلال، أسافر له بالسيارات أو القطار، وبعد ذلك أركب الحمار، لكي أسجل لهذا الشخص. وعندما كنت أجد أحد أبناء هؤلاء الفقراء مريضاً كنت أقوم بالانفاق عليه. وهذا ما جعل الكثير من إخواننا الأكاديميين يهاجمونني، ويقولون أنت الذي جعلت الشعراء يطالبون.
ما حقيقة موقفك من اتحاد الكتاب المصري، وتهديدك بالاستقالة من عضويته؟ هل لهذا الاتحاد من دور في الثقافة المصرية؟
للأسف اتحاد كتاب مصر كان من المفترض أن يؤدي دوراً أفضل مما يؤديه. والحقيقة أن القائمين عليه لا نعرف لهم إبداعا حقيقياً. وكان لي موقف واضح منه منذ إنشائه في السبعينات، ورفضت أن أكون عضوا به، لكن رئيس الاتحاد الكاتب الكبير سعد الدين وهبة رحمة الله عليه، هو الذي تشاجر معي عقب إحدى الأمسيات الشعرية وقال: «هل من المعقول أن أكون رئيساً لاتحاد الكتاب وعبد الرحمن الأبنودي ليس عضواً به، لازم أنا مش عاجبك». على الفور قبلت وشاركت، ولكن سعد الدين وهبة خانني ومات، وترك لي هذه العضوية. فبقيت ثلاث سنوات بعده حتى هانت عليّ روحي ووجدت الحكاية غير مرضية، فكتبت استقالتي وأرسلتها تلغرافياً. وهم يقولون إنني لم أستقل وأرسلت الاستقالة، ولم أذهب إلى هناك وأسحب طلبا وأكتب الاستقالة، ولكن أنا لن أذهب إليهم.
تعايشت مع عبد الناصر والسادات ومبارك، أي من الثلاثة بحق، أقرب الى هموم وأوجاع المصريين؟
لا نستطيع أن ننكر دور الزعيم عبد الناصر. أما عن المآخذ عليه، فأنا أتخيل نفسي رئيس دولة ومن حولي خمسة آلاف من الشخصيات الأمناء الذين أثق فيهم ويقدمون لي التقارير، هل أنزل بنفسي للتحقق من صحة هذه التقارير. عندما يصبح هؤلاء الأمناء ليسوا أمناء، فهم خائنون. نحن لم نخرج من السجن إلا أثناء زيارة وفد برئاسة المفكرة الفرنسية سيمون دي بفوار. فقد رفض الوفد زيارة بلد به أدباء محبوسون، فوعدهم عبد الناصر بأن يفرج عن كل الأدباء، يوم وصولهم إلى مصر، وبالفعل خرجنا. عند اعتقالنا لم توجه لنا تهمة، وفترة الاعتقال كانت جميلة، ولو كنا نعلم بحلاوتها لطلبنا الاعتقال بأنفسنا. ولا ننسى أن عبد الناصر هو الذي قال «ارفع رأسك يا أخي انتهى عهد الاستعباد». كان الفقراء وقت عبد الناصر يأكلون ويشربون وينامون ويحلمون، حتى ان الناس حين كان يموت أبناؤهم في الحروب يخفف الرئيس من حزنهم. عبد الناصر قام ببناء السد العالي، ولولا السد لحدثت كوارث مثلما حدث في السودان. عبد الناصر هو الذي بنى المصانع والقطاع العام، لكن كل ما بناه باعوه الآن. يا من تهاجمون عبد الناصر قولوا لنا: ماذا فعلتم؟ لولا عبد الناصر ما استطاع الفقراء من أمثالي أن يتعلموا. في هذا الزمان الذي يتفاخرون بأنه لم يقصف فيه قلم، هناك خمسة رؤساء تحرير للصحف حُكم عليهم بالسجن، فقط لأنهم نقلوا تساؤلات المصريين عن صحة الرئيس. كانوا يشاهدونه في التلفزيون والجرائد وفجأة اختفى لمدة عشرة أيام. من الطبيعي أن يكتب الصحافيون هواجس الشارع ولا يتم حبسهم. عندما مات عبد الناصر، كان في خزينته 350 جنيها ولو وجدوا عنده مبالغ كبيرة لكانوا قطّعوه. الآن بيعت كل الأشياء التي صنعها عبد الناصر، ولم نعرف قيمة هذا الرجل إلا بعد وفاته، وتولي الأنظمة الأخرى.
هل أنصفك النقاد في مصر؟
لا توجد حركة نقدية حقيقة في مصر. لكن يحتضنني الناس حين يلتقونني في الشارع ويقولون إن الكلام الذي كتبته في مجلة كذا أو جريدة كذا، جيد أو رديء فأستمع إليهم، لأن حبهم هدية وهبة من الله، وهذا لا يأتي من فراغ، وإنما من متابعتهم لإبداعاتي.
فيما يستمر إبداعك الشعري بروحه الخاصة، لماذا توقف إبداعك الغنائي واختفت أغنياتك التي طالما هزت المشاعر والوجدان؟
بخصوص الشعر، هناك تجربة فريدة وهي تسجيل دواويني على شرائط كاسيت، أصبحت تُهدى في المناسبات. أما بخصوص الأغنية، نحن جئنا في فترة مهيأة تماماً لكي نصدح، ولم نصدح بكل ما أردنا. الآن لأن الأغنية تحولت إلى سلعة تباع وتشترى، طردني ذلك أوتوماتيكياً من دائرة الأغنية التي أصبحت مثل زجاجة المياه الغازية تشربها وترميها في سلة المهملات أو في عرض الطريق. الأغنية لم يعد لها دور أو هدف أو معنى. إنه زمن الباعة، وليس من حقنا أن نبدي رأينا فيما يباع.
هل أنت راض عن مشوار حياتك؟
الحمد لله، راض عن حياتي وما قدمت من إبداع. لا بد أن تنظر دائماً إلى ما هو قادم ولا تنظر إلى الماضي. قد أكون أحسنت في أشياء وأخطأت في غيرها، ولكن لو انشغلت بتقييمي لماض لشغلت عن ما هو قادم، وهمي دائماً أن أقدم الجديد.
كنت صديقا لنجيب محفوظ كيف تراه الآن؟
كنا نلتقي معاً كل يوم ثلاثاء، في إحدى العوامات، وكنت دائماً أقول له الحمد لله إنك لم تكن شاعراً. كان يضحك ويقول لماذا؟ فأجيبه: ما تكتبه هو أشبه بالشعر ولكن الناس يسمونه رواية، ولو كنت شاعراً لأخذنا حقائبنا وعدنا إلى بلادنا. لقد ترك محفوظ فراغا إنسانيا وأدبيا يصعب تعويضه.